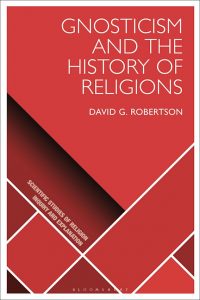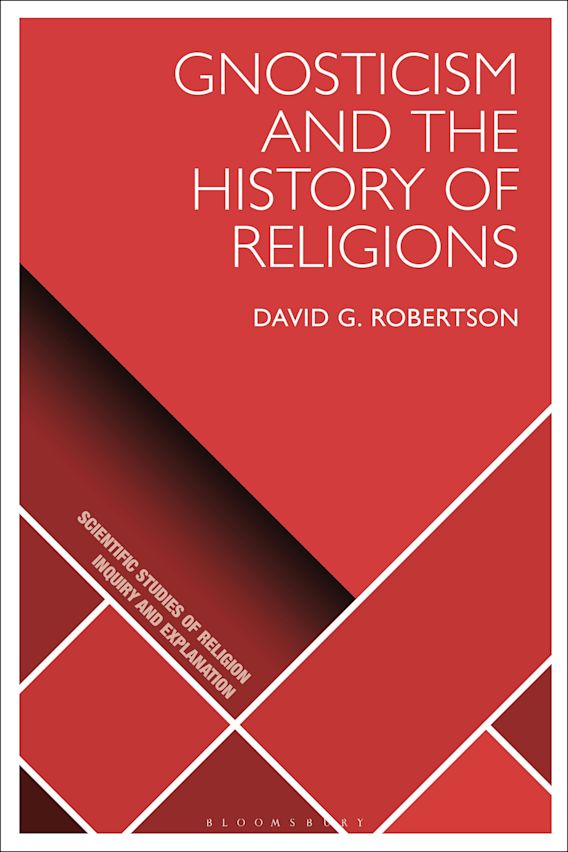ليس من السهل الكتابة عن مثل هذا الكتاب؛ لاسيما وأن موضوعه -بادي الرأي- هو موضوع متخصص نوعًا ما، وربما لو تصفحه القارئ العادي مباشرة ودون تمهيد لعدّه من الكتابات المتخصصة جدا نظرًا للغته واصطلاحاته وأفكاره التي يعرضها. وإن ما يجعل كتابة مقدمة لمثل هذه الأعمال مهمة شاقة هو أن القارئ المهتم -ولكن غير المتخصص- يعوّل عليها في تلمّس خطواته الأولى نحو فهم المبادئ والمصطلحات والخطوط العريضة لموضوع الكتاب، وما يتطلبه ذلك من خلفيات معرفية مسبقة -خارجة عن الموضوع- افترض المؤلف وجودَها لدى قرائه. ولا أزعم أن هذه المقدمة تغني عن الدراسة المتدرجة للموضوع، بل هي بالأحرى محاولة لتزويد القارئ غير المتخصص بالأفكار والمصطلحات التي تعينه على فهم الموضوع.
ليست الغنوصية بالموضوع الجديد على المكتبة العربية؛ فهناك عددٌ لا بأس به من الدراسات حول الغنوصية، سواء المكتوبة بالعربية [1] أو المترجمة [2]، لاسيما الكتابات التي تصدرها الأقسام العلمية الملحقة بالكنائس الشرقية المختلفة. هذا بجانب خروج ترجمات عربية لعدد كبير من النصوص المبكرة الموصوفة بأنها نصوص غنوصية [3]. والمطّلع على الدراسات الكتابية بشكل عام، والهرسيولوجيا heresiology (دراسة الهرطقات (البدع) المخالفة للمسيحية الأرثوذكسية، وهي توازي “الملل والنحل” في العلوم الإسلامية) بشكل خاص؛ سيدرك على الفور أن دراسة الغنوصية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتاريخ المسيحي المبكر.
حتى وقت ليس ببعيد، كانت كل معارفنا عن الغنوصية مستمدة من الكتابات الدفاعية التي صنفها آباء الكنيسة في الرد على الهرطقة الغنوصية. وتحوي هذه الكتابات خلاصات عن عقائد الغنوصيين، واقتباسات من كتاباتهم المفقودة، وأسماء أهم الشخصيات المرتبطين بهذه الهرطقة، أما نصوص الغنوصيين أنفسهم فكانت في عداد المفقود حتى وقت قريب. وقد شكلت هذه الكتابات الدفاعية مجمل تصور الباحثين عن الغنوصية، ولم يكن ثمة جديد يمكن إضافته على ما هو موجود في تلك الكتابات الدفاعية بسبب عدم وجود مصادر أخرى.
يمكننا أن نرصد حدثين كبيرين كان من شأنهما أن يعيدا كتابة تاريخ المسيحية المبكرة، ويلقون بظلال من الشك على التصور السائد لدى الكنائس عن تلك القرون، ويقوضون الكثير من الدعائم التي قامت عليها الدراسات الكتابية؛ الحدث الأول هو اكتشاف مخطوطات نجع حمادي عام 1945، والحدث الثاني هو اكتشاف مخطوطات قمران (مخطوطات البحر الميت) بين عامي 1946 و1947؛ وذلك لأن مخطوطات نجع حمادي تقدم نصوصًا اعتُبرت أناجيل هرطوقية كانت في عداد المفقود، من ثم فإن دراستها تؤثر مباشرة على طبيعة العهد الجديد المعترف به حاليًا. أما مخطوطات قمران فتقدم نسخًا للعهد القديم مغايرة لتلك المعروفة الآن والمعترف بها أيضًا. لذلك فإن هذه الاكتشافات تعيد رسم خارطة الكتاب المقدس بشقيه العبري والمسيحي، ولهذا السبب تستحوذ على اهتمام الدراسين في الشرق والغرب.
وحسب ما يذكر القس بولس الفغالي؛ [4] فنصوص نجع حمادي هي:
بيستس صوفيا (يسميها الفغالي: الإيمان الحكمة)
المقال التدرجي الكبير (متعلق بالتنجيم وبه مخططات سحرية)
- الطبوغرافيا السماوية
- إنجيل مريم المجدلية
- كتاب الأسرار ليوحنا
- حكمة يسوع
- عمل بطرس
- كتاب يعقوب السري
- إنجيل الحقيقة
- مقال في القيامة
- المقال المثلث الأقسام
- صلاة بولس
- إنجيل توما (توأم المخلص)
- إنجيل فيليب (فيليبوس)
- رسالة حول أصل العالم
- تأويل النفس
- رسالة حول الأراكنة
وبالتزامن مع ظهور تلك النصوص؛ كانت دراسة الظواهر الدينية قد أفلتت من سياج الكنيسة وسرديتها الدينية، وبرزت مناهج مختلفة لتفسير ودراسة الظواهر الدينية وبناء معرفة وتصور جديد عن الدين بشكل عام؛ منها المنهج الفينومينولوجي الذي يعود لهوسرل ونسخته الوجودية التي تعود لهايدجر؛ والنزعة الجوهرانية/الماهوية التي هيمنت على دراسة تاريخ الأديان في عدد من الجامعات الغربية؛ وسيكولوجيا كارل يونغ، وغيرها من المناهج التي يجمع بينها أنها تقارب الدين باعتباره تجربة إنسانية بحتة، أججها تفاعله مع بيئته وعالمه. والجدير بالذكر أن هذه المناهج تعود أصولها لفلاسفة هم في أحسن أحوالهم “لا دينيون”، وربما منهم من صرح بإلحاده، على الرغم من استعمال العديد من الدارسين المسيحيين في الغرب لبعض هذه المناهج، وهو ما يوضحه الفصلان الرابع والخامس.
لكن رغم أهمية هذه الاكتشافات، ورغم أن الكتابات الحديثة عن الغنوصية كُتبت بعد الاطلاع على نصوص نجع حمادي، أو على الأقل كان مؤلفوها على دراية بما تكشف عنه؛ إلا أن نصوص نجع حمادي -كما يبين الفصلان السادس والسابع- لم تحقق التأثير المراد منها؛ إذ ظلت الصورة التي رسمتها الكتابات الدفاعية حاضرة لدى الكُتاب ذوي الخلفية الدينية، وأما غيرهم ممن اعتمدوا المناهج الحديثة -لا سيما المقاربة الفينومينولوجية والوجودية للدين- فلم يلتفتوا للإشكالات التي تطرحها هذه النصوص الجديدة وحاولوا بناء تصورهم عن الغنوصية مدفوعًا بموقفهم من مشاكل عالمهم، حتى ليمكننا أن نجد لدى كل جماعة “غنوصيتهم” التي تعكس موقفهم من العالم؛ وفي هذا الصدد ظهرت الغنوصية باعتبارها انتفاضة على مادية الحداثة (الفصل السابع والثامن). والكتاب بالأساس يحاول تتبع هذه التمثلات الحديثة للغنوصية وعلاقتها بالبحث الأكاديمي ومناهجه.
من الناحية اللغوية؛ فإن كلمة الغنوصية مشتقة بالأساس من لفظة gnosis اليونانية، والتي تعني المعرفة/العرفان. [5] و”الغنوص Gnosis” هي كلمة يونانية تدل على المعرفة بشكل عام، ولها أشباه في عدد من اللغات الهندوأوروبية مشتقة من الجذر نفسه، مثل الكلمة السنسكريتية “جناناJnana ، والكلمة الإنكليزية Know بمعنى يعرف، وKnowledge بمعنى معرفة”.[6]
الغنوصية والشبق المعرفي
والمقصود بالغنوص المعرفة الباطنية التي تنطلق من عمق الإنسان، ولا تطلب شيئًا خارجه. وموضوعها هو الأسرار الإلهية، التي لا يرقى الجميع لمعرفتها، بل تخص فئة معينة، ترتقي فوق العامة الذين لا يعرفون إلا ظاهر الأمور. [5] وهي شكل من المعرفة الدينية موضوعها واقع الإنسان في حقيقته وروحانيته، نقلها “مُخلّص” فكشفها في تقليد باطني خاص؛ فاستطاعت هي بدورها أن تخلّص الذين يتقبلونها. [7]
ولكن المعرفة التي يسعى إليها الغنوصي ليست تلك التي يكتسبها بإعمال العقل المنطقي وقراءة الكتب وإجراء التجارب والاختبارات، وإنما هي فعالية روحية داخلية تقود إلى اكتشاف الحالة الإنسانية، وإلى معرفة النفس، ومعرفة الله الحي ذوقًا وكشفًا وإلهامًا. وهذه المعرفة هي الكفيلة بتحرير الروح الحبيسة في إطار الجسد المادي والعالم المادي الأوسع لتعود إلى العالم النوراني الذي صدرت عنه. فالروح الإنسانية هي قبسٌ من روح الله، وشرارة من النور الأعلى وقعت في ظلمة المادة، ونسيت أصلها ومصدرها. والإنسان في هذه الحياة أشبه بالجاهل أو الغافل أو النائم أو السكران، ولكن في أعماق ذاته هنالك دوما دعوة إلى الصحو عليه أن ينصت لها، ويشرع في رحلة المعرفة التي تحوله من نفس مادية حبيسة الشهوة، إلى نفس عارفة أدركت روابطها الإلهية وتهيأت للانعتاق الذي يعود بها إلى ديارها. [6]
وحسب ما يرى القس بولس الفغالي؛ فإن مبتدأ التحرر الغنوصي هو قلق يصيب الإنسان في الصميم، سواء كان مسيحيًا أو وثنيًا، فيتولد لديه شعور بالغربة والانعزال تجاه الكون، لهذا يحكم الغنوصي حكما قاطعًا سلبيًا على العالم بقواه التي تحتفظ به سجينا، ويسعى للبحث عن العنصر الروحي. فالغنوصي غريبٌ عن هذا العالم، وموطنه البليروما عالم الملء/الملاء، المضاد لعالم الخواء المادي. فالعالم الغنوصي هو عالم الانقسام، عالم التعارض والهوة الكيانية التي تفصل النور عن الظلمة في الكون، والروحاني عن المادي لدى الإنسان. [7]
تستند الغنوصية من ثم إلى ثنائيات متعارضة: المعرفة والجهل، الخير والشر، الحياة والموت، الروح والجسد، النور والظلمة، إله الخير وإله الشر؛ وهناك مقاومة جذرية بين كل عنصر وآخره داخل كل زوج. ويشير الفغالي إلى أننا نرى هذه الثنائيات في إنجيل يوحنا؛ فنرى التعارض بين بين النور والظلمة، بين الحق والباطل، وفي سفر الرؤيا نجد المسيح والمناوئ للمسيحي. وتنعكس هذه الثنائيات على إدراك الغنوصي لنفسه، فيتصورها في إطار هذه الثنائيات؛ فيكتشف في داخله النور والظلمة، الخير والشر، نتائج حضور الإله الصالح والإله الشرير. إنه ممزق بين مملكتين، فينتمي إلى الوحدة وإلى الانقسام، ووضعه هذا يعكس التعارض بين مبدأ الخير ومبدأ الشر. [8]
وحضور هذه الثنائية، واحتباس الإنسان في هذا العالم يعني أنه لا خلاص للإنسان سوى بالغنوصية والعرفان. وحدها المعرفة -بالمفهوم الغنوصي- هي التي تفتح ثقبًا في السور المحيط بالعالم. وليس العالم وحده هو السجن، بل البشرية نفسها هي بالنسبة إلى الغنوصي سجن يجب أن يفلت منه؛ ومن ثم فكل ما يرتبط بالبدن ورغباته فاسدٌ وشر. ومن أجل هذا تحرّم الغنوصية الحياة الجنسية والولادة؛ فالخليقة نفسها هي الشر.
“فالإنسان سجينُ جسده؛ وهو أيضا سجين العالم الذي هو وحولٌ وأسمالٌ وظلمات، ولن يتحرر من هذا الليل الذي يحيط به إلا بالمعرفة؛ وهكذا ينقسم العالم إلى عوالم تشكل للإنسان سجونا تحبسه بلا رحمة. يحرس هذه السجون تنانين يجب التغلب عليها لعبور أبوابها، وتسمي الغنوصية هذه التنانين أسياد العالم وأراكنته (جمع أركون Archon)؛ وهي تشبه آلهة الكون لدى الكلدانيين”. [9]
وفي النهاية، تعلن الغنوصية أن الكون شر كله؛ وهو لا يمتلك ذرة من نور. لهذا يشبه بجهنم، ووحدها النفس الروحانية الأعلى تشكل قبسًا من نور لا يشتعل إلا بقدر ما يتعلق بالعالم الآخر. وفي النسخة المانوية، تخف قوة هذه الثنائية وحدتها؛ فلم يعد العالم كله شريرًا، بل يمتلك كل جوهر فيه وجهه الخير ووجهه الشرير.
أما الإله الذي يبحث عنه الغنوصي في أعماق ذاته، فليس هو الإله الذي صنع هذا العالم المادي الناقص والمليء بالألم والشر والموت، بل هو الآب النوراني الأعلى الذي يتجاوز ثنائيات الخلق، ولا يحده وصف أو يحيط به اسم، وهو الذي وصفه (كتاب يوحنا السري) بالكلمات التالية: “الواحد الموجود بصمديته، القائم بنوره. البداية التي لم تسبقها بداية. بلا حدود ولا أبعاد؛ لعدم حدوث شيء قبله يحدده ويقيس أبعاده، خفيٌ لم يره أحد. بلا أوصاف لأن أحدًا لم يفهم كنهه فيصفه. بلا اسم، لعدم وجود أحد قبله يطلق عليه الاسم، قائم بنفسه ولنفسه وراء الوجود ووراء الزمن”.[6]
ويرى السواح أن ما يميز الغنوصية عن المسيحية الأرثوذكسية، هو أن عالم المادة المرئي بالنسبة للغنوصيين ليس من صنع الله (النوراني الأعلى) وإنما من صنع إله أدنى هو إله اليهود، الذي يوازي “أنجرا مانيو” شيطان الزردشتية. وتتصوره الأدبيات الغنوصية على شكل مسخ مزيج من هيئة الأفعى وهيئة الأسد وله عينان تشبهان جمرتين من نار، يجلس على عرش يحيط به معاونوه من قوى الظلام المدعوون بالأراكنة (مفردها أركون، أي الحاكم ذو البطش باللغة اليونانية)، ويدعي: يهوه و«یلدابوث» في الأدبيات الغنوصية، ويلقب بـ “اسكلاس” أي الأحمق، وبـ “اسمائيل” أي الأعمى، وبـ “الديميورغ” أي الإله صانع العالم المادي باللغة اليونانية (Demiourgos). وعلى الرغم من أن هذا الإله قد صنع الإنسان من مادة الأرض الظلامية نفسها، إلا أنه أخذ روحه من نور الأعالي وحبسها في قوقعة الجسد، ولكي يبقيه في حُجُب الجهل فرض عليه الشريعة التي تشغله عن نفسه وعن اكتشاف الجوهر الحقيقي للروح.[10]
هذه السمة الثنوية التي تميز الغنوصية ورؤيتها للشر الكامن في المادة والعالم، تضمر وراءها مشكلة الشر أو سؤال العدالة الإلهية؛ وهو ما سيظهر جليًا في بعض التكييفات الحديثة للغنوصية (الفصل السابع) لاسيما مع كارل يونغ، الذي سيسقط هذه السمات السلبية لخالق الكون المادي على إله العهد القديم، ثم الإله عمومًا، رادًا الدين والتجربة الدينية كلها إلى توهمات نفسية. ولا يخفى أن الأزمات التي تعرضت لها الحداثة والحضارة الغربية من حربين عالميتين، عززت هذه الشظايا الكامنة لدى الوعي الأوروبي حول العدالة الإلهية. والأسوأ أن دارسي الغنوصية من الباحثين اليهود لما حاولوا تحسين صورة إلههم (يهوه) وإنقاذه مما اعتبروه مأزقًا أخلاقيًا تمثل في “صمته” عن الهولوكوست، سلبوه القدرة على التدخل في العالم؛ فالعقل اليهودي الغربي لكي يحل المأزق الذي أقحم نفسه فيه حول العدالة الإلهية؛ إما أنه أقر بعجزه عن التدخل لمنع الشر فجعله إلها عاجزًا، أو أنه جعله إلهًا غائبًا لا يهمه شأن هذا العالم بأي حال. ويمكننا رد جذور هذا التصور إلى الكتاب المقدس نفسه الذي يظهر من بعض أسفاره امتعاض من يتعرضون للبلاء، حتى وضعوا على ألسنة الأنبياء بعضًا من هذا السخط (وهو ما يظهر مثلا من سفر الجامعة (كوهيليث) وسفر أيوب). [11]
وفي خلاصة موجزة، يمكننا أن نجمل عناصر البنية العقائدية للفكر الغنوصي فيما يلي [12]:
الواحد الأحد (الموناد)
يسمى الإله الواحد الخفي لدى الغنوصيين بـ “الموناد”، وهو علة الملاء الأعلى التي هي منطقة النور. ويسمى ما فاض عنه بـ “الإيون”، وهو قديم، رغم أن له بداية.
الملاء الأعلى (بليروما)
هو مركز الحياة الإلهية، ومنطقة النور التي تتخطى عالمنا، يقيم بها مخلوقات روحية مثل الإيون وبعض الأراكنة (خدم وحراس الخالق المادي الذين يتصلون بالبشر). ويعتقد بعضهم أن المسيح هو من الإيون الذي أرسل من الملاء الأعلى إلى الأرض ليدل البشر على إعادة اكتشاف المعرفة التي تعيد إليهم المعرفة الإلهية المفقودة.
الفيض
يعتقد الغنوصيون بأن النور الإلهي يفيض نزولًا عبر سلسلة من المراحل والتدرجات والعوالم، حتى ينتهي إلى العالم المادي. ثم يعاود الترقي بشكل عكسي ليعود إلى الواحد الأحد عن طريق التأمل والمعرفة الروحية.
الإيون
فيضٌ من الواحد الأحد، وكل إيون له نظيره السلبي؛ وبحسب النصوص، وصل عددهم إلى ثلاثين زوج.
الحكمة (صوفيا)
تعتبر الحكمة هي أدني مستويات فيض الواحد الأحد ومنها وُجد خالق العالم المادي، ديميورغ.
خالق العالم المادي (ديميورغ)
عند الغنوصيين، هو فيضٌ من الحكمة، وهو المسؤول عن خلق الكون المادي والبشر.
خدم خالق العالم المادي (أركون)
استعمل بعض الغنوصيين مصطلح “أركون” (خدم الرب) اسمًا لبعض خدم خالق المادة (ديميورغ)، وهم من سماهم العهد القديم بالملائكة.
أصول الغنوصية وأبرز ممثليها
تحتل مسألة أصل الغنوصية مركز الصدارة في عامة الكتابات التي تناولتها؛ ويعرض المؤلف في مختلف فصول الكتاب هذا الانقسام الحادث بين الباحثين حول هذه المسألة؛ فمِن قائل بأصول شرقية للغنوصية تعود إلى الديانات التي تتابعت على الحضارة الفارسية والهندية، ومِن رافض لهذه الأصول الشرقية معتبرًا أن الغنوصية ذات أصول غربية وأنها تكييفٌ هيليني للمسيحية، ومن هؤلاء من يعدها الصورة النقية الأولى للمسيحية قبل أن تفسدها الكنيسة الكاثوليكية. وأما الباحثون اليهود فكان لهم نصيب أيضًا من هذه المناقشات، وادعوا في أكثر من مناسبة أن الغنوصية يهودية المنشأ، ولكنهم اضطروا لتأويل تلك الصورة السلبية التي يتبناها الغنوصيون عن إله العهد القديم باعتبار أن الغنوصيين لم يكونوا يوجهون سهام غضبهم نحوه، بل نحو صانع العالم المادي، وليس يهوه. ومرد هذا التنوع في الرؤى هو تحرر غالب الكتابات الغربية من الصورة التي تتبناها الكنيسة عن الغنوصية، واعتمادهم مناهج بحثية مختلفة لا يهمها كثيرًا الرواية المسيحية التي تعتبر الغنوصية هرطقة أو تحريف للمسيحية، بل ربما ناصبوها العداء.
وأما الأدبيات العربية؛ فلا عجب أن تدور الكتابات المسيحية باللغة العربية في فلك فكرة الأصل المسيحي للغنوصية وأنها استمدت أصولها من تيارات عدة؛ فيرى بولس الفغالي مثلا أن الغنوصية استعارت عناصر من مختلف التيارات الفكرية الناشئة داخل الفكر المسيحي؛ وهو ما يجعلنا أمام “ديانة” تلفيقية، تختلف نظرتها باختلاف المناهج الداخلة في تكوينها.[13] ويوسع السواح هذه الرؤية معتبرًا أن الغنوصية بالأساس لونٌ من المسيحية المغايرة للمسيحية الأرثوذكسية -وهي الرؤية التي يفندها المؤلف هنا- استدمجت عناصر من الفلسفة الأفلاطونية، التي ميزت بين التفكير العقلاني المنطقي، والخبرة الداخلية الحدسية التي تقود إلى معرفة الله، وتكشف للروح الإنسانية صلتها بعالم الألوهية. وإلى هذه الفلسفة ترجع الثنوية البادية في الغنوصية، فهذه الفلسفة الأفلاطونية -حسب ما يقرره السواح- تقر بوجود ديميورغ يتوسط بين الملأ الأعلى والعالم المادي، وسمته “الإله الثاني”. كما يرى السواح أن الغنوصية تشربت عناصر شرقية من المتون الهرمسية [14]
وقد ارتبطت بالغنوصية العديد من الأسماء التي سيتردد صداها وصدى أفكارها في ثنايا الكتاب، وقد رأينا إجمال أفكار أهم هذه الشخصيات حتى يكون القارئ غير المتخصص على دراية بأصول المقولات التي يعرضها المؤلف.
فالنتينوس[15]
اتخذت الغنوصية شكلها الناضج على يد معلمها الكبير فالنتينوس، الذي وُلد بمنطقة الدلتا المصرية لأسرة ذات أصول يونانية عام ۱۰۰م. تلقى تعليمه بالإسكندرية، مدينة العلم والثقافة في ذلك العصر، وبؤرة إشعاع الفكر الأفلاطوني والهرمسي. ثم اتصل بالمسيحيين وأعتبر نفسه مسيحيًا، ولكنه شكّل لنفسه مجموعة غنوصية داخل كنيسة الإسكندرية، وأسس أكاديمية للبحث الحر. وكما تصفه الكتابات الدفاعية لآباء الكنيسة؛ اعتبر فالنتينوس نفسه المفسر الحقيقي لتعاليم المسيح، بعد أن نقل إليه معلمُه ثيوداس تعاليم بولس السرية، وأدخله إلى حلقة الباطنيين المتحدين بالآب الأعلى. وقد بلغ من ثقته بنفسه أنه رشح نفسه لمنصب أسقف روما في أواسط القرن الثاني الميلادي، على الرغم من أن تعاليمه تشكل انشقاقا تامًا عن لاهوت العهد القديم، وتقدم تفسيرات جد مختلفة لحياة يسوع ورسائل بولس.
يرى فالنتينوس أن بؤس الإنسان ناجمٌ عن سجن روحه في المادة المظلمة، ذلك السجن الذي وضعه فيه يهوه، إله العهد القديم، وأن هذا الإله الذي يعبده البسطاء ليس إلا ظلًا للإله الحقيقي، وأن تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية التي يبشر بها آباء الكنسية التقليدية لا تمت لصلة للإله الحق العلي الخفي، بل تتعلق بالديميورغ (صانع العالم المادي) الذي يحكم العالم ببطشه، ويتصرف كقائد عسكري؛ وهو الذي فرض الشريعة، ويعاقب على انتهاكها. ولكن بسطاء العوام الذين عبدوا صانع العالم المادي، سوف يتعلمون كيف يرفضون سلطته، ويتمردون على شريعته، وذلك بعد تلقيهم الأسرار ودخولهم حلقة العارفين الغنوصيين. وهو ما يقودهم بالتالي إلى نبذ سلطة التراتبية الكنسية التي تستمد سلطتها من الديميورغ لا من الأب الأعلى.
ويقرر فالنتينوس أن العرفان/الغنوص يؤدي إلى الخلاص والتحرر من عالم المادة، وذلك بعد أن يتعرف الغنوصي على الإله الحق، وعلى طبيعته الروحانية التي هي جزء من طبيعة الإله. وعلى الرغم من أن هذا العرفان ذو طابع فردي في أساسه، ويؤدي إلى خلاص فردي في النهاية، إلا أن كل فعالية عرفانية فردية سوف تؤثر على صيرورة الكون برمته، وتساعد في النهاية على خلاص العالم ككل، كما تساعد على إصلاح الإله المادي (يهوه/ الديميورغ)، لأنه جهولٌ بطبعه ومحروم من العرفان اللازم لخلاصه، ولكن الإنسان قادر على معونته وتحريره من خلال عرفانه الداخلي.
الجدير بالذكر أن أتباع فالنتينوس لم ينشقوا عن الكنيسة رغم أن كل تعاليمهم ضدها، بل اعتبروا أنفسهم على الدوام جزءًا منها. وما تعلمه الكنيسة هو بالنسبة إليهم مرحلة أولية ملائمة لعقول العامة، تعتمد الظاهر من الاعتقاد، أما هم فهم الخواص الذين يعلمون الحقائق العليا الباطنة.
باسيليد[16]
في القرن الثاني الميلادي أنتج باسيليد منظومة عقائدية تتعلق بأصل الكون والعالم موازية للسردية التي يقدمها سفر التكوين؛ حيث يقرر أنه في البداية لم يكن سوى العدم والإله الخفي المتشح بالعدم. ثم فاض عن هذا الإله الخفي بذرة الكون التي تضم كل ما هو موجود بالقوة، مثلما تحتوي حبة الخردل بالقوة على الجذور والساق والأوراق. ومن هذه البذرة خرج الأركون الأكبر المدعو “يهوه”، وباشر خلق العالم المادي من بذرة الكون، [17] دون أن يعلم بوجود الإله الخفي الأسمى منه.
وبعد أن خلق يهوه العالم المادي، خلق الإنسان، ثم اختار شعبًا خاصا له أراد له أن يخضع بقية أمم الأرض، ولكن الآب ضابط الكل أرسل ابنه المسيح (اللوغوس/الكلمة) لتخليص هذه الأمم. وعندما أسلمه يهوه إلى الصلب، اتخذ سمعان القريني، الذي كلف بحمل الصليب، شكل يسوع، بينما اتخذ يسوع شكل سمعان القريني، وراح يضحك من جهل اليهود الذين شبه لهم أنهم صلبوه).
سمعان ماجوس [18]
سمعان ماجوس (المجوسي)، أو سمعان الساحر، هو أحد رموز الغنوصية في الشام، وهو أكثر الشخصيات الغنوصية غموضًا، لأن مؤلفاته قد ضاعت، ولم يبق منها إلا أفكار متفرقة وصلت إلينا عن طريق نقاده المسيحيين. وقد امتلأ ما وصلنا إليه من سيرته بالخوارق والمعجزات، حتى ضاعت ملامح سيرته الحقيقية. نشط سمعان خلال أواسط القرن الأول الميلادي. وهذا يعني أنه قد عاصر يسوع، ونشط خلال فترة نشاط الرسل الأوائل؛ ومن الشذرات اليسيرة التي وصلتنا عنه، لا يبدو سمعان يهوديًا ثائرًا على الأرثوذكسية اليهودية، ولا صاحب مسيحية غنوصية متطرفة؛ وإنما تنبع غنوصيته -على ما يرى السواح- من مصدر ثالث، هو على ما يبدو الغنوصية المبكرة التي نشأت عن الموروث الوثني التقليدي للمنطقة.
يقول سمعان -وفقًا لناقده هيبوليتوس- بأن الإله قوة أزلية موحدة وغير متمايزة، منغلقة على نفسها في صمت مطلق. ثم إن هذه القوة اتخذت شكلا وانقسمت على نفسها، فظهر العقلNous، وهو مذكر، والفكرة Enoia وهي مؤنثة. وبذلك انشطرت الألوهة إلى قسم علوي هو عالم الروح، وقسم سفلي هو عالم المادة. وقد امتصت الفكرة (إنويا) القوى الخلاقة للآب وأنتجت ملائكة، عملت بواسطتهم على صنع العالم المادي. ولكن إنويا فقدت السلطة على القوى التي فاضت عنها، وصارت أسيرة لها ولا تستطيع الرجوع إلى الآب. وهنا ظهر سمعان ماجوس تجسيدًا للآب على الأرض لكي يحرر إنويا من قيودها، ويقدم الخلاص من العالم المادي لكل من يتعرف عليه، بصفته هذه، من البشر.
وفي الختام؛ فقد أرفقنا الترجمة بعدد من الحواشي التوضيحية التي تبين بعض المصطلحات التي ربما تكون غامضة على القارئ، وميزناها بكلمة (المحرر) حتى لا تختلط بهوامش المؤلف. ويجدر التنبيه إلى أننا أبقينا على المصطلحات المتداولة في هذا الحقل، بصيغتها المعروفة حتى لا يتشتت القارئ إذا أراد البحث عنها في المصادر. كما أبقينا على بعض الأسماء الأجنبية للكتب التي ذكرها المؤلف -وهي كثيرة- وليس لها ترجمات عربية (وغالبها كذلك) بحيث يسهل البحث عنها.
الهوامش- أشهر هذه الكتابات هي: الحركة الغنوصية في أفكارها ووثائقها، للخوري بولس الفغالي، نشر الرابطة الكتابية. الوجه الآخر للمسيح، فراس السواح. الغنوصية أو التيارات العرفانية في القرون المسيحية الأولى، للأب يوسف توما مرقس. الغنوصية: نشأتها وصلتها بالفلسفة اليونانية، د. محمد أحمد ملكاوي.[↩]
- أشهرها كتاب: الديانة الغنوصية، لهانز يوناس، وخصص المؤلف له الفصل الثالث.[↩]
- منها: أبوكريفا العهد الجديد، للدكتور سالم الطرزي، الكتابان الثاني والثالث بعنوان: مكتبة نجع حمادي.[↩]
- الحركة الغنوصية في أفكارها ووثائقها، للخوري بولس الفغالي، ص160.[↩]
- الحركة الغنوصية في أفكارها ووثائقها، للخوري بولس الفغالي، ص5.[↩][↩]
- الوجه الآخر للمسيح، فراس السواح، ص150.[↩][↩][↩]
- الحركة الغنوصية في أفكارها ووثائقها، للخوري بولس الفغالي، ص6.[↩][↩]
- الحركة الغنوصية في أفكارها ووثائقها، للخوري بولس الفغالي، ص14.[↩]
- الحركة الغنوصية في أفكارها ووثائقها، للخوري بولس الفغالي، ص15.[↩]
- الوجه الآخر للمسيح، فراس السواح، ص152.[↩]
- من المفارقات أن أحد الأدباء الفرنسيين الملحدين بعد قراءة سفر الجامعة (المنحول على لسان سليمان عليه السلام وهو منه براء) تساءل كيف لهذا السفر “الملحد” والذي يظهر صاحبه تمردًا على الإله وامتعاضًا من قراراته أن يجد مكانًا له ضمن الأسفار المعترف بها للكتاب المقدس؟ انظر: Frédéric Schiffter, Le charme des penseurs tristes, (2013), p.52[↩]
- الغنوصية أو التيارات العرفانية في القرون المسيحية الأولى، للأب يوسف توما مرقس، ص34-40.[↩]
- الحركة الغنوصية في أفكارها ووثائقها، للخوري بولس الفغالي، ص16.[↩]
- Corpus Hermeticum، وهي عبارة عن ثلاث عشرة رسالة منسوبة إلى هرمس المثلث العظمة، كانت متداولة في الإسكندرية، وفي الدوائر الباطنية في العالم الهيلينستي خلال القرن الأول الميلادي. ويرى السواح أن هذه الرسائل كانت مصدر الأفكار الغنوصية التي تدور حول التناقض بين الروح والجسد، والنظر إلى الجسد باعتباره ممثلًا للظلام والمادة والموت، وإلى الروح باعتبارها ممثلة للنور والحقيقة الأبدية. ((الوجه الآخر للمسيح، فراس السواح، ص76.[↩]
- الوجه الآخر للمسيح، فراس السواح، ص80. الغنوصية، بولس الفغالي، ص55.[↩]
- الوجه الآخر للمسيح، فراس السواح، ص82.[↩]
- الخلق هنا معناه: إخراج ما هو بالقوة إلى ما هو بالفعل؛ وهو مفهوم فلسفي مضاد لمفهوم الخلق من العدم، ويرجع أصل هذه الفكرة إلى الفلسفة الأرسطية وتفريقها بين الهيولى والصورة.[↩]
- الوجه الآخر للمسيح، فراس السواح، ص85.[↩]